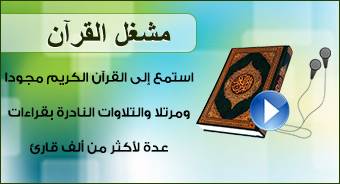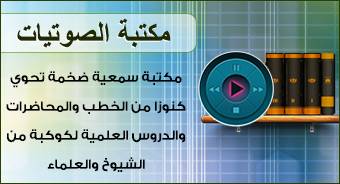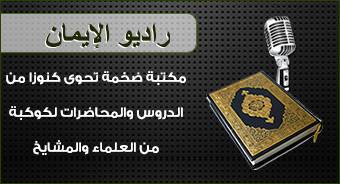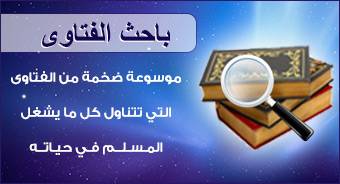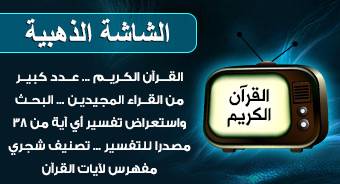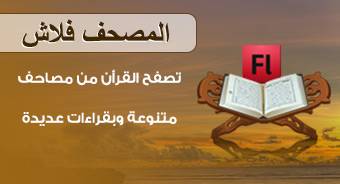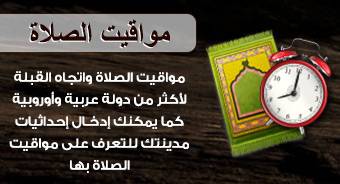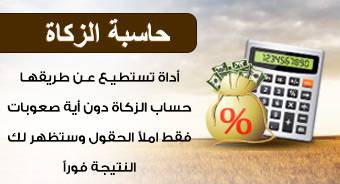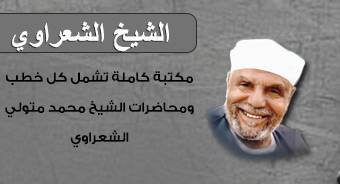|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن **
تستعمل متعدية، وهي تتعدى غالبًا إلى مفعولين، وفاعل هذه المتعدية لا يجر بالباء. كقوله: وتستعمل لازمة، ويطر، جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد الكفاية. كقَوْله في هذه الآية الكريمة ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء. وزعم بعض علماء العربية: أن جر فاعلها بالباء لازم. والحق أنه يجوز عدم جره بها، ومنه قول الشاعر: عميرة ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
وقول الآخر: ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدى عما غيب المرء مخبرا
وعلى قراءة من قرأ {يلقاه} بضم الياء وتشديد القاف مبنيًا للمفعول ـ فالمعنى: أن الله يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة. فحذف الفاعل فبني الفعل للمفعول. وقراءة من قرأ {يَخْرُجُ} بفتح الياء وضم الراء مضارع خرج مبنيًا للفاعل ـ فالفاعل ضمير يعود إلى الطائر بمعنى العمل وقوله {كتابا} حال من ضمير الفاعل. أي ويوم القيامة يخرج هو أي العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه كتابًا يلقاه منشورًا. وكذلك على قراءة {يَخْرُجُ} بضم الياء وفتح الراء مبنيًا للمفعول، فالمضير النائب عن الفاعل راجع أيضًا إلى الطائر الذي هو العمل. أي يخرج له هو أي طائره بمعنى عمله، في حال كونه كتابًا. وعلى قراءة "يخرج" بضم الياء وكسر الراء مبنيًا للفاعل، فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى، وقوله {كتابا} مفعول به. أي ويوم القيامة يخرج هو أي الله له كتابًا يلقاه منشورًا. وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة ـ فالنون في {نُخْرِجُ} نون العظمة لمطابقة قوله {ألزمناه} و{كتابا} مفعول به لنخرج كما هو واضح. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة. كقوله: فقوله {وَلاَ تَزِرُ} أي لا تحمل، من وزريزر إذا حمل. ومنه سمي وزير السلطان، لأنه يحمل أعباء تدبير شؤون الدولة. والوزر: الإثم. يقال: وزر يزر وزرا، إذا أثم. والوزر أيضًا: الثقل المثقل، أي لا تحمل نفس وازرة أي آثمة وزر نفس أخرى. أي إثمها، أو حملها الثقيل. بل لا تحمل إلا وزر نفسها. وهذا المعنى جاء في آيات أخر. كقوله: وقد قدمنا في سورة "النحل" بإيضاح: أن هذه الآيات لا يعارضها قوله تعالى: تنبيه يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان: الأول ـ ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من "أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه" فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء غيره. إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره؟ السؤال الثاني ـ إيجاب دية الخطإ على العاقلة. فيقال: ما وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟. والجواب عن الأول ـ هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين: الأول ـ أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه. كما قال طرفة بن العبد في معلقته: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقى على الجيب يابنة معبد
لأنه إذا كان أوصى بأن يناح عليه: فتعذيبه بسبب إيصائه بالمنكر. وذلك من فعله لا فعل غيره. الثاني ـ أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه. لأن إهماله نهيهم تفريط منه، ومخالفة لقوله تعالى: وعن الثاني ـ بأن إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم وزر القاتل، ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني. لأن الجاني لم يقصد سوءًا، ولا إثم عليه البتة ـ فأوجب الله في جنايته خطأ الدية بخطاب الوضع، وأوجب المواساة فيها على العاقلة. ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه مواساة بعض خلقه. كما أوجب أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء. واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطأ كأبي حنيفة وغيره ـ أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان. ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: "وأجمع أهل السير والعلم: أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام . وكانوا يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك. حتى جعل عمر الديوان. واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان، وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدًا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. قوله تعالى: وقد أوضح جلَّ وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين. بينها في آخر سورة طه بقوله وأشار لها في سورة القصص بقوله: ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله جلَّ وعلا لا يعذب أحدًا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام ـ تصريحه جلَّ وعلا في آيات كثيرة: "بأن لم يدخل أحدًا النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل. فمن ذلك قوله جلَّ وعلا: ومعلوم أن قوله جلَّ وعلا: قال أبو حيان في "البحر المحيط" في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها ما نصه: "وكلما" تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين. ومن ذلك قوله جلَّ وعلا: وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم. لعمومها في كل ما تشمله صلاتها، وعقده في مراقي السعود بقوله في صيغ العموم: صيغة كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع
ومراده بالبيت: أن لفظة "كل، وجميع، والذي، والتي" وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم. فقوله تعالى: ونظيره أيضًا قوله تعالى: ونظير ذلك قوله تعالى: وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر. وبهذا قالت جماعة من أهل العلم. وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير، واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله، وبأحاديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى: وظاهر جميع هذه الآيات العموم. لأنها لم تخصص كافرًا دون كافر، بل ظاهرها شمول جميع الكفار. ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أَنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، أَين أَبي؟. قال: "في النَّار" فلما قفى دعاه فقال: "إنَّ أَبي وأباك في النَّار" اهـ وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضًا: حدثنا يَحْيَى بن أيوب، ومحمد بن عباد ـ واللفظ ليحيى ـ قالا: حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد يعني ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: زار النَّبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأَبكى من حوله. فقال: "استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكِّر الموت" اهـ إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة. وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول ـ هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم. أو معذورون بالفترة؟ وعقده في "مراقي السعود" بقوله: ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع
وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار: النووي في شرح مسلم، وحكى عليه القرافي في شرح التنقيح الإجماع. كما نقله عنه صاحب "نشر البنود". وأجاب أهل هذا القول عن قوله تعالى: الأول ـ أن التعذيب المنفى في قوله ونسب هذا القول القرطبي، وأبو حيان، والشوكاني وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور. والوجه الثاني ـ أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: الوجه الثالث ـ أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. كإبراهيم وغيره. وأن الحجة قائمة عليهم بذلك. وجزم بهذا النووي في شرح مسلم، ومال إليه العبادي في (الآيات البينات). الوجه الرابع ـ ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، الدالة على أن بعض أهل الفترة في النار. كما قدمنا بعض الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره. وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة ـ فأجابوا عن الوجه الأول، وهو كون التعذيب في قوله: الأول ـ أنه خلاف ظاهر القرآن. لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقًا، فهو أعم من كونه في الدنيا. وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه. الوجه الثاني ـ أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة. كقوله: وأجابوا عن الوجه الثاني ـ وهو أن محل العذر بالفترة في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد ـ بنفس الجوابين المذكورين آنفًا. لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن، فلا بد له من دليل يجب الرجوع إليه، ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنيا، بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضح، كما تقدم إيضاحه. وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي، ومال إليه العبادي وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلم بأنه قول باطل بلا شك. لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه، لأن مقتضاه أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل والقرآن ينفي هذا نفيًا باتًا في آيات كثيرة. كقوله في "يس": وأجابوا عن الوجه الرابع ـ بأن تلك الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره أخبار آحاد يقدم عليها القاطع، وهو قوله: وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضًا عن الآيات التي استدل بها مخالفوهم كقوله: فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم، وما لم يخرجه دليل خاص بقي داخلًا في العموم. كما تقرر في الأصول. وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام. لأن الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف. وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، وأشار لأن ذلك الإنصاف الكامل، والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب. فلو عذب إنسانًا واحدًا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها، ولثبتت لذلك الإنسان الحجة التي أرسل الله الرسل لقطعها. كما بينه بقوله: وأجاب المخالفون عن هذا ـ بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة، وحصلت علة الحكم التي هي عدم الإنذار في الدنيا، مع فقد الحكم الذي هو عدم التعذيب في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها. فإن وجود علة الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلاح أهل الأصول. بـ "النقض" تخصيص للعلة، بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العام. أي قصره على بعض أفراده بدليل. والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة، أو تخصيص لها معروف في الأصول، وعقد الأقول في ذلك صاحب "مراقي السعود" بقوله في مبحث القوادح: منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر إن جا لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع
فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض: هل هو تخصيص، أو إبطال للعلة، مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال المذكورة. واختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم عن الوصف إن كان لأجل مانع منع من تأثير العلة، أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة، وإلا فهو نقض وإبطال لها. فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعًا. فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان، ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعًا من تأثير العلة في الحكم ـ فلا يقال هذه العلة منقوضة. لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة، بل هي علة منع من تأثيرها مانع. فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع. وكذلك من زوج أمته من رجل، وغره فزعم له أنها حرة فولد منها. فإن الولد يكون حرًا، مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعًا. لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها. لأن الغرور مانع منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد. وكذلك الزنى: فإنه علم للرجم إجماعًا. فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا الحكم الذي هي الرجم، ونعني بذلك الشرط الإحصان. فلا يقال إنها علة منقوضة، بل هي علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا كثيرة جدًا. هكذا قاله بعض المحققين. قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر: أن آية "الحشر" دليل على أن النقض تخصيص للعلة مطلقًا، والله تعالى أعلم. ونعني بآية "الحشر" قوله تعالى في بني النضير: ثم بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله: فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور تخصيص للعلة لا نقض لها. والعلم عند الله تعالى. أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا فهو تخصيص للعلة إجماعًا لا نقض لها. كما أشار له في الأبيات بقوله: * والوفق في مثل العرايا قد وقع * قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا؟ هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها. فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا. ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا. لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين: الأول ـ أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوته عنه نص في محل النزاع. فلا وجه للنزاع ألبتة مع ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها، بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة، رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم، بأن الآخرة دار جزاء لا عمل، وأن التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق وهو لا يمكن ـ ما نصه: والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط، أفادت الحجة عند الناظر فيها. وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاء، فلا شك أنها دار جزاء، ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار. كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال، وقد قال تعالى: وقد ثبت في الصحاح وغيرها: "أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقًا واحدًا، كلما أراد السجود خر لقفاه". وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها: "أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك منه، ويقول الله تعالى: يا بن آدم، ما أعذرك? ثم يأذن له في دخول الجنة" وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار، وليس ذلك في وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث. "فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط وهو جسر على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم، كالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب. ومنهم الساعي، ومنهم الماشي، ومنهم من يحبو حبوًا، ومنهم المكدوس على وجهه في النار" وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل هذا أطم وأعظم? وأيضًا ـ فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه يكون عليه بردًا وسلامًا. فهذا نظير ذلك. وأيضًا ـ فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم. فقتل بعضهم بعضًا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفًا، يقتل الرجل أباه وأخاه، وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم. وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل. وهذا أيضًا شاق على النفوس جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضًا قبل هذا الكلام بقليل ما نصه: ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر. فمن أطاع دخل الجنة، وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة. ومن عصى دخل النار داخرًا، وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة، الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب (الاعتقاد) وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو واضح جدًا فيما ذكرنا. الأمر الثاني ـ أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف. لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان. فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان، ويتفق بذلك جميع الأدلة، والعلم عند الله تعالى. ولا يخفى أن مثل قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن الآخرة دار جزاء لا دار عمل ـ لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم. كما أوضحناه في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب). قوله تعالى: الأول ـ وهو الصواب الذي يشهد له القرآن، وعليه جمهور العلماء ـ أن الأمر في قوله {أَمْرُنَا} هو الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره. والمعنى: {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} بطاعة الله وتوحيده، وتصديق رسله وأتباعهم فيما جاؤوا به {فَفَسَقُواْ} أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم، وعصوه وكذبوا رسله وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة. كقوله: ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: فقوله في هذه الآية وبهذا التحقيق تعلم: أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من أن معنى {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} أي أمرناهم بالفسق ففسقوا. وأن هذا مجاز تنزيلًا لإسباغ النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة الأمر بذلك ـ كلام كله ظاهر السقوط والبطلان. وقد أوضح إبطاله أبو حيان في "البحر"، والرازي في تفسيره، مع أنه لا يشك منصف عارف في بطلانه. وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف، من قولهم: أمرته فعصاني. أي أمرته بالطاعة فعصى. وليس المعنى: أمرته بالعصيان كما لا يخفى. القول الثاني في الآية ـ هو أن الأمر في قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} أمر كوني قدري، أي قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له. لأن كلًا ميسر لما خلق له. والأمر الكوني القدري كقوله القول الثالث في الآية ـ أن "أَمَرْنَا" بمعنى أكثرنا. أي أكثرنا مترفيهًا ففسقوا. وقال أبو عبيدة {أَمْرُنَا} بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا بالمد. ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير مال امرىء مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة". قال ابن كثير: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه (الغريب): المأمورة: كثيرة النسل. والسكة: الطريقة المصطفة من النخل. والمأبورة: من التأبير، وهو تعليق طلع الذكر على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردًا عن الزوائد، متعد بنفسه إلى المفعول. فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد تعدى أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد بن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج، كقولهم: الغدايا والعشايا، وكحديث "ارجعن مأزورات غير مأجورات" لأن الغدايا لا يجوز، وإنما ساغ للازدواج مع العشايا، وكذلك مأزورات بالهمز فهو على غير الأصل. لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز في قوله "مأزورات" للازدواج مع "مأجورات". والازدواج يجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله "مأمورة" إتباع لقوله "مأبورة" وإن كان مذكورًا قبله للمناسبة بين اللفظين. وقال الشيخ أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قوله تعالى {أَمْرُنَا} قرأ أبو عثمان النهدي، وأبو رجاء، وأبو العالية، والربيع، ومجاهد، والحسن "أمرنا" بالتشديد. وهي قراءة على رضي الله عنه. أي سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. وقال أبو عثمان النهدي "أمَّرنا" بتشديد الميم: جعلناهم أمراء مسلطين. وقاله ابن عزيز: وتأمر عليهم تسلط عليهم. وقرأ الحسن أيضًا، وقتادة، وأبو حيوة الشامي، ويعقوب، وخارجة عن نافع، وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس باختلاف عنهما "آمرنا" بالمد والتخفيف. أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها. قاله الكسائي. وقال أبو عبيدة: "آمرته ـ بالمد ـ وأمرته لغتان بمعنى أكثرته. ومنه الحديث "خير المَال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة" أي كثيرة النتاج والنسل. وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعنى واحد. أي أكثرنا. وعن الحسن أيضًا، ويحيى بن يعمر: أمرنا ـ بالقصر وكسر الميم ـ على فعلنا، ورويت عن ابن عباس. قال قتادة والحسن: المعنى أكثرنا، وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد. وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد، وأصلها أأمرنا فخفف ـ حكاه المهدوي. وفي الصحاح: قال أبو الحسن: أمر ماله ـ بالكسر ـ أي كثر. وأمر القوم: أي كثروا. قال الشاعر وهو الأعشى: طرفون ولادون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد
وآمر الله ماله ـ بالمد. الثعلبي: ويقال للشيء الكثير أمر. والفعل منه أمر القوم يأمرون أمرًا: إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أمر أمر بني فلان: قال لبيد: كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يومًا يصيروا للهلك والنكد
قلت: وفي حديث هرقل الحديث الصحيح. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. أي كثر. وكلها غير متعد، ولذلك أنكره الكسائي. والله أعلم. قال المهدوي: ومن قرأ أمر فهي لغة. ووجه تعدية أمر أنه شبهه بعمر من حيث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العمارة. فعدى كما عدى عمر ـ إلى أن قال: وقيل أمرناهم جعلناهم أمراء. لأن العرب تقول: أمير غير مأمور، أي غير مؤمر. وقيل معناه: بعثنا مستكبريها. قال هارون: وهي قراءة أبي: بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا فيها ـ ذكره الماوردي. وحكى النحاس: وقال هارون في قراءة أبي: وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول اهـ محل الغرض من كلام القرطبي. وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية: أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا. فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم إيضاحه. تنبيه في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال: إن الله أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله والجواب من وجهين: الأول ـ أن غير المترفين تبع لهم. وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم وكبراؤهم. لأن غيرهم تبع لهم. كما قال تعالى: الوجه الثاني ـ أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع. كما قال تعالى: وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع جهات: الأولى ـ أن في الآية تهديدًا لكفار مكة، وتخويفًا لهم من أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلها. أي أهلكنا قرونًا كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسل، فلا تكذبوا رسولنا لئلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم. والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة. كقوله في قوم لوط الجهة الثانية ـ أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر. فبينت كيفية إهلاك قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وفرعون وقومه من قوم موسى، وذلك مذكور في مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى. وبين أن تلك القرون كثيرة في قوله: وهذا المعنى تدل عليه آيات أخر. كقوله ويدل على هذا قوله: الجهة الرابعة ـ أن قوله والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدًا. كقوله:
|